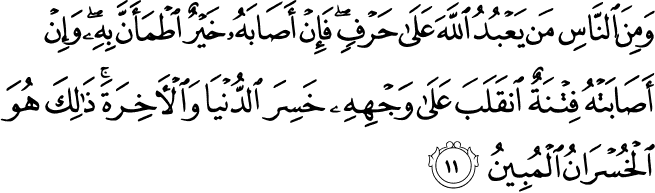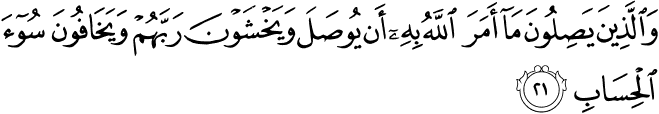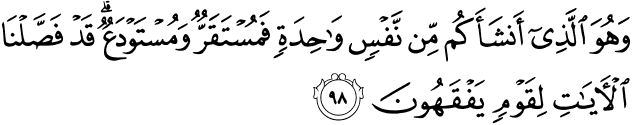حديث حول سورة الطور-5

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وخاتم النبيين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد, وعلى آله الأخيار الأبرار، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وأفتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك.
استكمالاً للحديث حول سورة الطور والتي ذكرنا أنَّها بدأت بأقسامٍ خمسة:
- فأقسمت أولاً بالطور.
- ثم أقسمت بكتابٍ مسطور.
- وبعده أقسمت بالبيت المعمور.
- فهذه أقسامٌ ثلاثة بعد ذلك قال الله تعالى: ﴿وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ﴾(1).
المراد من السقف المرفوع:
والمراد من السقف المرفوع كما رُوي عن أمير المؤمنين (ع) هو السماء(2). فهي السقف المرفوع التي أقسم الله بها في هذه السورة المباركة، وقد وصف القرآن السماءَ بالسقف في آياتٍ أخرى كما في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاء سَقْفًا مَّحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ﴾(3)، ووصفها بالرفعة في أكثر من آية، قال تعالى: ﴿وَالسَّمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ﴾(4)، وقال جلَّ وعلا: ﴿اللّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا﴾(5) فالمراد من السقف المرفوع في الآية المباركة من سورة الطور هي السماء التي فوقنا.
الغاية من القسم بالظواهر الكونيَّة:
أقسم الله عزَّ وجلَّ بها للتعبير عن مظهرٍ من مظاهر عظمته جلَّ وعلا. وقد ذكرنا مراراً عديدة أنَّ القرآن كثيراً ما يُقسم بالظواهر الكونيَّة ليستثير بذلك انتباه الإنسان إلى ما حوله فينتقل منه إلى مُبدِعِ ذلك المظهَر الكوني العظيم، فكثيراً ما يغفل الإنسان عمَّا حوله، رغم كثرةِ وتنُّوع ما يُشاهده من بدائع هذا الكون والمعبِّرة -لو تنبَّه- عن جلال الله تعالى وعظيم قدرته وبديع حكمته لكنَّه غافلٌ، مشغولٌ عنها باهتماماته الضيِّقة وشؤوناته الخاصَّة، لذلك قد يقوده هذا الذهول وتقوده هذه الغفلة إلى نسيان ربِّه جلَّ وعلا، وقد تقوده الغفلةُ إلى التنكُّر والجحود.
أمَّا الإنسان البصير الذي هو دائم التأمُّل ودائمُ النظر لما حوله من بديع هذا الكون فهو مذعنٌ بأنَّ هذا الكون وعظمته وإتقانه ودقته والقوانين التي تحكمه تُعبِّر عن خالقٍ حكيم عالمٍ قادرٍ متقِن، فتقوده هذه الآيات الناشئة عن هذا النظر والتأمُّل إلى الإيمان والإذعان بوجود الله عزَّ وجل. لذلك اهتمَّت الآيات الكريمات في موارد كثيرة بهذا النمط من الإثارة والتحفيز الذهنى للإنتباه، لأنَّه كثيراً ما يكون الإنسان غافلاً عمَّا حوله، فالقسَمُ بهذه الظواهر الكونية يُحفِّر في ذهن الإنسان حالة التنبُّه إلى هذا الكون وعظمته.
تنبُّه الإنسان إلى ما حوله يُفضي إلى الإذعان بوجود الله وعظمته:
كلُّ يومٍ يرى الإنسان الشمسَ وهي تُشرق ثم يراها تغرب، ويرى القمر في الليل، ويرى تعاقب الليل والنهار، ويرى النجوم السابحات في السماء والتي يفوق عددها الآلاف وربَّما الملايين، يرى هذا الكون برحابته وسعته، يرى الأرض وما تُنبت من بديع خلق الله من أجناسٍ وأصنافٍ تفوق حدَّ الإحصاء: من النباتات، والأشجار، والورود، والأزهار، والمرعى، وغيرها. ثم لا يلتفت، يرى البحر وسعته وما يكتنز من أسرارٍ ومن كائناتٍ حيَّة وغيرها. ويرى أصناف الحيوانات والبهائم والوجودات والكائنات الحيَّة أصنافاً لا يسعه أن يحصيها فهي -كما يقول العلماء- تفوق الآلاف من الأصناف وليس الأعداد: أصناف الحيوانات، وأصناف الطيور، وأصناف الحشرات والديدان. وكلُّ ذلك قائمٌ على أطرٍ وقوانين وأسس.
فالكون مليء بالآيات والأسرار، لكنَّ الإنسان سادرٌ غافلٌ، لذلك جاء الأنبياء للتنبيه، لم تكن وظيفة الأنبياء أكثر من التنبيه، كلُّ حديثهم مغروزٌ في فطرة الإنسان، فدورهم يتمحَّضُ في الإشارة والتنبيه، فالإنسان مفطورٌ على الإيمان بالله عز وجل والإدراك البديهي لوجود الله تعالى وقدرتِه وعظيمِ شأنه، يكفي أن ينتبَّه الإنسان إلى ما حوله، وأن ينظر إلى ذاته، وإلى مكامن نفسه، وإلى تركيبه، وإلى جوارحه، و إلى كيفية تفكيره، وإلى مشاعره، يكفي أن ينظر إلى كلِّ ذلك ليُذعن بوجود الله عزَّ اسمه وتقدس، لكنَّ الغفلة هي التي تحجبُ الإنسان عن الإيمان بالله جلَّ وعلا، لهذا كان دور الأنبياء هو التنبيه وتحفيز العقل والقلب للرجوع إلى ما تقتضيه جبلَّة الإنسان وفطرته.
لهذه الغايةِ أقسم القرآن في هذه الآية بالسقف المرفوع وهي السماء، فلو تأمَّل الإنسان هذه السماء التي فوقه وما تكتنز من أسرار، فهي التي تحمي الأرض لتكون بذلك مؤهَّلةً وقادرةً على أن تحتضن الإنسان وسائر الكائنات الحيَّة. فلولا السماء وما اشتملت عليه من قوانين لأصبحت هذه الأرض غير قابلة للحياة، فلولا ذلك لما كانت الحياة ممكنة على هذه الأرض. فالإنسان يعيش وادعاً هادئاً مستقراً مطمئناً في هذه الأرض، لا يخشى من شيء. فالأشعة التي التي يكفي صنفٌ منها لتدمير الأرض وتحويلها إلى موضعٍ غير قابلٍ للحياة. هذه السماء، هذا الغلاف هو الذي يحيمها من ذلك، فيظلُّ الإنسان هادئاً مستقراً آمناً في هذه الحياة ليُمارس دوره.
ينام الإنسان ويغطُّ في النوم وثمة مَن يُدبِّر شأنه:
لو تأمل الإنسان ذلك لشعر أنَّ هناك مَن يكلؤه ويحفظه ويُدبِّر شأنه وهو لا يشعر، فهو ينام ويغطُّ في النوم وثمة مَن يُدبِّر شأنه، فهو في غفلةٍ حتى عن نبضات قلبه التي هي سرُّ بقائه على قيد الحياة، فهو ينام ويستيقظُ ذاهلاً عن قلبه، وهو يظلُّ ينبض بالحياة، فليس هو من يرعى ذلك، ودورته الدموية ليس هو الذي يرعاها وليس هو الذي يدبِّر شأنَ جريانها في عروقه، فكلُّ ذلك يُدبِّره مَن خلقه، لذلك فهو ينام ويسعى ويُمارس شؤوناته وثمة من يُدبِّر شؤونه، فنبضاتُ قلبه تتحرك بالنحو المقرَّر لها دون أن يكون له دخلٌ فيها، وإذا شاء الله تعالى أن يوقف نبض قلبه أوقفه دون أن يكون للإنسان رأيٌ في ذلك.
المراد من البحر المسجور:
ثم أقسم الله عزَّ وجل بقسَمٍ خامس قال تعالى: ﴿وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ﴾(6).
ربَّما يكون المراد من البحر المسجور -كما هو أحد المعنيين المذكورين في التفاسير- هو البحر المملوء بالماء المتلاطم الذي يحوط الأرض كلَّ الأرض.
القسم بالبحر يستثير عقل الإنسان:
أليس من الحكمة أن يستثير هذا المظهر الكوني عقل الإنسان. هذا الماء الذي لم ينضب على مدار آلاف آلاف السنين، يحوط هذه اليابسة، يصلُ عمق بعض جوانبه ما يفوق أعلى جبلٍ في الأرض، ويكتنز هذا البحر الكثير من الأسرار، لذلك ينبغي للعاقل أن يتأمل مَن الذي أنشأ هذا البحر؟ وعلى هذه الهيئة، وبهذه العظمة، فينبغي أنْ يتأمل فيما اشتمل عليه من أسرار وقوانين وإبداعات وكائناتٍ حيَّة، فحتى الآن ورغم أنَّ العلم قد تقدم كثيراً لم تُكتشف كلُّ أسرار هذا البحر.
فالقرآن أراد بهذا القسَم أنْ يستثير عقل الإنسان ليتوجَّه إلى هذا المظهر الكوني العظيم من أجل أن ينتقل منه إلى مَن الذي كوَّن هذا البحر وخلق هذه السماء وبسط هذه الأرض بهذا الإتقان وبكلِّ هذه الآثار حيثُ ما من شيء من هذه الظواهر الكونية إلا وله غاية وفائدة لا يمكن الاستغناء عنها. هكذا أراد القرآن أن يستثير عقل الإنسان.
﴿وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ * وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ﴾(7).
ما هو جواب هذا الاقسام؟
الجواب هو قوله تعالى: ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ * مَا لَهُ مِن دَافِعٍ﴾(8)
قضاءٌ محتوم لا مردَّ له، ولا دافع له، ولا مانع منه. ومن ذلك يتَّضح الغرض من القسم بمثل السماء المتعاظمة في الإحكام والارتفاع وبمثل البحر الزاخر بالأسرار والمحيط بالأرض، الغرض من القسم بمثل هذه الأقسام هو التأكيد على انَّ وعيده بإيقاع العذاب لا يعجزه انجازه، فهو لن يكون أعظم من خلق السماء.
الغرض من القسم هو أنْ يُؤخذ الوعيد الإلهي مأخذَ الجد:
لا حظوا حينما يأتينا رجلٌ ضعيف وهو يُزبِد ويُرعِد ويتوعَّد فإننا لا نعبأُ بوعيده وقد نسخر منه، رغم أنَّه توعَّد بأمورٍ خطيرة فقال مثلاً: انَّه سيقتل، وسيُحرق، وسيفعل العظائم من الأمور، رغم ذلك لا يعتني السامع بوعيده بل ولا يُدير له بالاً، لماذا؟ لأنَّ المتوعِّد ضعيف، مُستحقَر، يعلم السامع انَّه لا يستطيع أن يفعل شيئاً مما توعَّد به، فوعيده أشبه بالسراب في نظر السامع، لذلك لا يرعى له أهمية.
أما عندما يصدر الوعيد من رجلٍ قوي متنفِّذ له سلطان، وقد أثبتت التجارب أنَّ له الكثير من الأفعال الكبيرة والخطيرة، أليس من التعقُّل أن تأخذ وعيده مأخذ الجد؟ ألا تكون من الحمقى عندما لا ترعى أهميةً لوعيده؟
هذا ما أراد القرآن الإشارة إليه في هذه الآية، أراد القول بأنَّ الذي يتوعَّد بالعذاب هو خالق السماء، الذي يتوعد بالعذاب هو خالق البحر المسجور، الذي يتوعَّد بالعذاب هو الذي خلق هذا الكون بسعته بمجرَّاته بأفلاكه بنجومه بكواكبه. هذا هو مَن توعَّد بالعذاب. فهل يستطيع الإنجاز لوعيده أو لا يستطيع؟! لا ريب في انَّه يستطيع، فالذي استطاع فعل كلَّ ما هو عظيم عندما يتوعَّد أحداً بعذاب فثقوا أنَّه قادرٌ على أن يُنجز وعيده.
فانتبهوا أيُّها السادرون، أيُّها الغافلون، أيُّها المغرورون الحمقى، فإنَّ عذاب ربِّك واقع، ومَن سيدفعه؟!! ﴿مَا لَهُ مِن دَافِعٍ﴾(9).
عندما يتوعَّد القوي بأمرٍ نقول: إنَّ فوق قوتك قوةً تمنعك، سنستندُ وسنلجأ إلى مَن هو أقوى منك ليدفع عنَّا وعيدك. أما حينما يتوعَّد القويُّ الذي ليس فوقه قوي، فإنَّ وعيده يكون غير مدفوع، فليس من أحدٍ قادرٌ على أنْ يدفع وعيده، هكذا أرادت الآية أن تقول، ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ * مَا لَهُ مِن دَافِعٍ﴾. فالذي يُمكن أن يُدفع وعيده بالعذاب هو من كان فوق قوته قوةٌ، فمثله يمكن دفع وعيده بتدخُّلِ تلك القوة، أما حينما يكون المتوعِّد بالعذاب هو أقوى من كلِّ قويٍّ على الإطلاق فلا تُدانيه قوة مهما تعاظمت بل انَّ كلَّ قوة فهي مستمدة من قوته فمَن يدفع وعيده عن أن يُنجزه؟! ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ * مَا لَهُ مِن دَافِعٍ﴾.
يخدع الإنسانُ نفسه إذا توهَّم أنَّ قدرته لا حدود لها ولا تخوم:
هنا ينبغي للعاقل أن تكون له وقفة تأمُّل. فالإنسان كثيراً ما ينتابه الغرور لذلك فهو يرتكب الكثير من الحماقات والأخطاء ويغفل عن ربِّه. يُحدِّثُ نفسه أنَّه حرٌّ له الاختيار في أن يفعل ما يُريد وأن يترك ما لا يُريد يُحدِّث نفسه انَّ له عقلاً واستعداداً ذهنياً يُؤهِّله أن يفعل الكثير في هذه الحياة، لذلك إذن فليس من قوةٍ أيَّاً كانت قادرةٌ على أن تستعبدني. هكذا يخدع نفسه بأنَّ قدرته لا حدود لها ولا تخوم، ولهذا يشعر بالكبرياء والاستعلاء، ليس السلاطين وحدهم الذين يُصابون بداء الاستعلاء والاستكبار. كثيرٌ من الناس من المثقفين منحوا الإنسان صفة الإله حيث قالوا: إنَّه قادرٌ على كلِّ شيء، ولا ينبغي أن يخضع لشيء، ولا أنْ يحدَّه شيء، ولا أن يحكمه شيء، هو يحكم نفسه بنفسه، هذا غرور، وهذا الغرور هو الذي يقود الإنسان إلى الهلاك.
قدراتك كلُّها ممنوحة:
قدراتك التي بيدك كلُّها ممنوحة من قبل الله عز وجل، ولو شاء الله عز وجل في أي لحظةٍ لسلبها. كنْ أعقل الناس وأكثرهم علماً وقدرةً على حلِّ أكثر القضايا الرياضية تعقيداً، وكن أعلم الناس في الفيزياء، وفي الأحياء، في الفلك، وفي علوم الطبيعة، وكنْ أمهر الناس في الصناعة والهندسة، هل تملك أنْ لا تفقد هذه القدرة؟ أنت قد وضعت رأسك على الوسادة ليلاً وكان رأسك محشواً بكلِّ هذه العلوم، هل تملك أن تستيقظ وعقلك لا زال محشواً بكل هذه العلوم؟ أَلا يمكن أن تفقد عقلك أو ذاكرتك؟ ألم تُعلِّمنا الأيام أنَّ الكثير من الناس قد فقدوا ما كانوا يعلمون؟ يبيت أحدنا وهو عالم ثم يُصبح وهو غير قادر حتى على الكلام، يُصاب بجلطةٍ أوعارضٍ آخر فتمتحي ذاكرته بأكملها، هل يملك أن يسترجعها ؟! وقد يفقد ذاكرته دون عارضٍ ظاهر فلا يملك أن يسترجعها. فلماذا هذا الغرور الذي ينتاب الإنسان؟! ولماذا كلُّ هذا الكبر والاعتداد بالنفس؟!
قصة:
يُذكر انَّ أحدهم كان في احدى الجامعات برتبة برفسور، وكان معروفاً بالقدرة المتميِّزة بين زملائه وبين طلابه، يحفظ الكثير من النصوص، ويُعالج الكثير من القضايا التي تتصل بتخصُّصِه، وكان يُشار إليه بالبنان، وكان مؤمناً صالحاً. استيقظ في يومٍ من الأيام فوجد نفسه لا يتذكر كيف يتوضأ، فهو قد نسي الوضوء الذي كان يُمارسه كل يومٍ مراتٍ عديدة، فسأل زوجته أو أحد أبنائه عن كيفيَّة الوضوء، فأخذ يقلده في كيفية الوضوء لأنَّه مؤمن لذلك فهو حريصٌ على أن يصلي. وقف للصلاة فأراد أن يتذكَّر سورة الحمد ولكن دون جدوى فأخذ مصحفاً ليقرأ سورة الحمد من المصحف فلم يُحسن أن يقرأ، فقد نسى القراءة فأصبح لا يُميِّز بين حروف الهجاء، كلُّ ذلك كان دون مرضٍ عضويٍّ ظاهر، فقد كان سليم الأعضاء ولا يشعر بألمٍ أو دوارٍ أو شبهه لكنَّه قد نسي الوضوء وسورة الحمد والصلاة ونسي ما كان قد حفظه من نصوص، ونسي الدروس التي كان يُلقيها، ونسي العلوم التي كان قد تلقَّاها، فهل يملك أن يسترجعها؟ ليس في وسعه ذلك ما لم يمنحه الله ويمنُّ عليه بعودة ذاكرته.
ليس لقضاء الله تعالى دافع:
فعذابُ الله إذا نزل بأحدٍ فليس له دافع، وإذا نزل قضاء الله فإنَّه ليس له دافع، ثم إنَّ الإنسان في مطلق شؤوناته ليس له من الأمر شيء، فهو حين وُلد لم يكن ذلك باختياره، ولم يكن باختيار أبيه، ولا باختيار أمه. وكذلك حينما يمَوت فإنَّ ذلك لا يكون باختياره، وهكذا فإنَّ تنقله من طورٍ إلى طور ومن مرحلة إلى أخرى لا يكون ذلك باختياره بل هو برعايةٍ تخفى على كلِّ أحد، ، فقد تتعطَّل عند الإنسان عملية النمو في لمحة بصر فيقد بدنه الأهلية على النمو فتُصبح أعضاؤه غير قابلةٍ للنمو، وثمة نماذج كثيرة في ذلك: يبدأ طبيعياً في نموِّه، فيكبر ويصل إلى سنِّ الثالثة مثلاً ثم يتوقَّف عنده النمو فلا يملك من أحدٍ أن يمنحه هذه الأهليَّة، لذلك يتوقَّف عند هذه المرحلة، وقد يموت في عمر العشرين وعقله وأعضاؤه تعمل بوظائف أعضاء ذي الثلاث سنين.
إذن فنموُّ أعضائك ليس باختيارك، ونموُّ عقلك ليس باختيارك، ونبضاتُ قلبك ليس باختيارك، وحركة الدورة الدموية في عروقك ليس باختيارك، أعصابك وعظامك ووظائف سائر أعضائك ليس شيء منها خاضع لاختيارك ورغبتك ثم بعد ذلك تقول: أنا أستطيع أن أفعل كلَّ شيء، أليس هذا غرور وغفلة واستخفاف بالنفس؟!
العاقلُ لا يعتدَّ بنفسه:
لذلك فينبغي للإنسان العاقل أن لا يعتدَّ بنفسه، فهو وإنْ كانت لديه قدرات ولكنَّها ممنوحة ولا يملك الاحتفاظ بها، ولهذا ينبغي أن يظلَّ هاجس فقدانها أو فقدان بعضها حاضراً في ذاكرته فذلك هو ما سيدفعه إلى أن يسأل الله عز وجل أنْ يديمها له، فهذا الهاجس هو ما سيبعث في قلبه الشعور بالافتقار الدائم لله تعالى، فيلجأ إلى ربِّه ليس في طلب عطاياه وحسب بل يلجأ إليه في طلب أن لا يسلبه صالح ما أنعم به عليه، فقد يمنحُ اللهُ الإنسان الكثير من النعم إلا انَّ الأمر لا ينتهي عند ذلك فقد تُسلب منه تلك النعم، فالكثير من الناس يُمسي وهو يرفل في النعم ثم يجد نفسه بعد أن أصبح وقد سُلبت منه تلك الخيرات التي منحت له. ولذلك يحسن بالمؤمن أن يدعو دائماً بهذا الدعاء المأثور: “اللهم لا تسلبنا صالح ما أنعمت به علينا”. هو أنعم عليك بالصحة، ولكنَّه قد يسلبها. وأنعم عليك بالعقل فترى نفسك مبجَّلاً محترماً بين الناس وإذا دخلت في محفلٍ قاموا لك إجلالاً، ويخشون من تجاوزك ويحسبون لك ألف حساب، وبعد يومٍ تُصبح معتوهاً مجنوناً يضحك عليك الصبيان. فهل تملك أن لا تفقد عقلك؟! فإذا فقد الإنسان عقله خرج إلى الطريق بلا ثياب، فصار محلاً لسخرية الأطفال وعبثهم، كلُّ إنسان فهو في معرض الوقوع في مثل هذه الحال، نسأل الله العافية.
وخلاصة الحديث هو أنَّ القرآن أراد أنْ يُشير هنا إلى أنَّه ليس من قوَّةٍ وإن تعاظمت قادرة على أنْ تدفع قضاء الله عزَّ وجل أو ترفعه: ﴿وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ﴾. فهو الذي يقضي بوقوع الضر على الإنسان لمصلحةٍ قد تخفى، وهو الذي يرفع عنه الضر إنْ شاء ﴿وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدُيرٌ﴾(10).
إذا أراد اللهُ تعالى بأحدٍ خيراً فلا رادَّ لفضله:
وكذلك لو أراد الله تعالى بأحدٍ خيراً فلا رادَّ لفضله، فالخلقُ عاجزون مجتمعين عن منع فضل الله تعالى عن أحدٍ أراد منحَه من فضله.
بعض العوائل الارستقراطية أو العوائل التي ترى لنفسها النُبل في اُوربا القديمة لا تتمنى أن يكون من أبناء غيرها نجباء وأذكياء، فهؤلاء يريدون الذكاءَ والنجابةَ في أبنائهم دون غيرهم، ويعملون على أن يكون الجمال في بناتهم وأولادهم دون غيرهم، لكنَّهم لا يملكون ذلك. فالكثير من العوائل التي ترى لنفسها النبل والتميُّز تبذل كلَّ قصارى جهدها لتحسين نسلها، حتى يكون نسلُها هو الأجمل، وحتى يكون نسلُها الأذكى، والأقوى والأشجع فيُفاجئهم القدر بنسلٍ مشوَّه أو مُعاق أو مبتلى بعاهةٍ مستدامة أو مرضٍ مزمن، وفي المقابل يُولد من بيتِ فقيرٍ معدّم ولدٌ نجيب يتميَّز بذكاءٍ يفوق كلَّ أقرانه دون أنْ يبذل ذلك الفقير عناءً يُذكر، فلم يكن قد تناول مأكولاتٍ خاصَّة ولا حظيَ ولدُه برعايةٍ خاصة ولا مدرسةٍ خاصة ولم يُستقدم له معلِّمون من أقطار الأرض، ورغم ذلك فهو يتفوَّق على الجميع، والتاريخ ببابكم فجلُّ عظمائه هم أبناء الفقراء.
إذن فهذا الذي يملك أسباب القوة لم يملك لنفسه ما يتمنَّاه، ولم يستطع أن يمنع غيره من الحسنى، فإذا أراد الله بأحدٍ خيراً فلا رادَّ لفضله، فهو تعالى إذا أراد أن يمنحَ عبداً من عباده فضلاً من فضله فإنَّه لو اجتمع أهل الأرض كلُّهم ليدفعوا ذلك الفضل فإنَّهم لن يستطيعوا إلا أنْ يشاء الله عز وجل، ﴿قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ * يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾(11).
والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور
1– سورة الطور الآية/5.
2– تفسير مجمع البيان – الشيخ الطبرسي – ج 9 ص 272.
3– سورة الأنبياء الآية/23.
4– سورة الرحمن الآية/7.
5– سورة الرعد الآية/2.
6– سورة الطور الآية/6.
7– سورة الطور الآيتان/5-6.
8– سورة الطور الآيتان/7-8.
9– سورة الطور الآية/8.
10– سورة الأنعام الآية/17.
11– سورة آل عمران الآيتان/73-74.